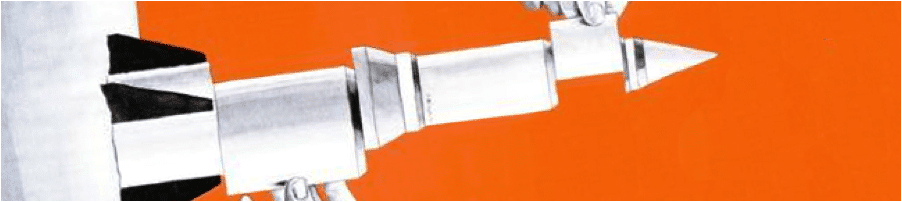التحديات تفوق الموارد
By Dalia el-Akkad (AR) |
رصدت الحكومة المصرية هذا العام ما يقرب من 1% من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق على البحث العلمي — وتزيد هذه النسبة بشكل كبير عن نسبة 0.23% المسجلة في عام 2011. ولكن العلماء على الرغم من ذلك يتقاضون رواتب ضعيفة، كما أن البنية التحتية في الجامعات والمراكز البحثية سيئة، مما يؤدي إلى هجرة العلماء إلى أماكن أخرى بحثاً عن مستويات معيشة أفضل وفرص أفضل للحصول على التكنولوجيا المتقدمة وظروف سياسية أكثر استقرارًا.
يشعر الصحفيون العلميون أنه يمكنهم القيام بدور مهم في إخراج العلوم في مصر من الورطة التي وقعت فيها. ولكن الصحفيون العلميون أنفسهم يواجهون تحديات خطيرة. وتعد السياسة واحدة من بين أكبر التحديات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتغطية القضايا النووية. وقد واجهتُ قبل الثورة مشكلة السرية الزائدة عندما كتبت حول موضوع ذي صلة بالبرنامج النووي للبلاد. حيث كان نظام مبارك يعتبر أي شيء يتعلق بالشئون النووية سريًا للغاية. وكانت هناك لجنة تراقب الصحافة لا تسمح سوى بنشر القليل حول هذه الموضوعات. ولم تكن تسمح بنشر أية اخبار في الشأن النووي إلا فيما يتصل بالتركيز على انجازات النظام. وحتى في الوقت الراهن، فشلت مسودة الدستور في توضيح الأمر فيما يتعلق بالتوتر الحادث بين الأمن الوطني من جانب وحرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومات من جانب آخر. (من المقرر أن ينتهي الاستفتاء على مشروع الدستور في 22 ديسمبر.)
مساحة صغيرة، وتمويل ضئيل. يغطي عدد محدود من الصحفيين العلوم، ويرجع ذلك في الغالب لأن وسائل الإعلام لا تزال غير مقتنعة بأن تغطية العلوم من الأمور الهامة. ويجد الكتاب العلميون صعوبة في النشر في الصفحة الأولى، ولا تخصص بعض الصحف والمجلات أي مساحة للأخبار العلمية على الإطلاق. ولا تحصل التغطية العلمية على التمويل الكافي، إما لأن الصحفيين الذين يتناولون القضايا النووية والعلمية يتقاضون مرتبات ضعيفة، وينتج عن هذا ضعف التغطية حيث يقدم الكُتاب أخبارًا مترجمة من مصادر غربية أو يعتمدون بصورة أساسية على النشرات الصحفية. وبالرغم من ذلك، لا يتم نشر نشرات صحفية إلا بواسطة عدد قليل من المراكز البحثية.
يهتم المتحدثون باسم الحكومات أكثر في العادة بالاجتماعات الرسمية وجداول سفرهم أكثر من اهتمامهم بتوفير المعلومات العلمية التي تهم القراء. ولا يسمح للصحفيين بالدخول إلى هيئة الطاقة الذرية المصرية، ولا يمكنهم التحدث مع أي من علمائها دون الحصول على إذن. وفوق ذلك، يرفض العديد من العلماء إجراء مقابلات صحفية لأن بعض الصحفيين لا يقومون بالإعداد للمقابلات بشكل مناسب، أو يقومون بنشر معلومات لا تتسم بالدقة.
القطار البطيء. يوجد تحد رئيسي آخر واجهته وهو الافتقار إلى الدورات التدريبية للأشخاص للعاملين في مجال تخصصي. وقد بدأت العمل كصحفية علمية في عام 2004، ولم تكن تتوفر أي دورات تدريبة للصحفيين العلميين على المستوى المحلي حتى عام 2008. وتم تمويل هذه الدورة التدريبية بواسطة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، بتعاون مالي مع الاتحاد الأوروبي – ولا تبدي الصحف المصرية بشكل عام اهتماماً بتوفير دورات تدريبية للعاملين لديها في مجالات متخصصة من هذا القبيل. ومن ثم ينبغي على الصحفيين أن يعتمدوا على أنفسهم ويحسنوا مهاراتهم من خلال القراءة المستقلة والسعي للحصول على الدورات التدريبية حيثما وجدت.
يمثل السفر للخارج لحضور المؤتمرات العلمية تحديًا كبيرًا آخر، فلا توفر معظم الصحف تمويلاً للصحفيين لحضور مثل هذه الفعاليات، وبالتالي ينبغي على المرء تأمين تمويل خارجي. وقد حضرت ست مؤتمرات علمية خارج مصر، إلا أن كل رحلة كان يتم تمويلها من قبل منظمة دولية تقديرًا منها لما أكتبه من مقالات.
هذا أمر مخزٍ، لأن المؤتمرات الدولية توفر أرضية خصبة للحوار والتواصل بين الأشخاص من العالمين المتقدم والنامي. وفي عام 2011، كان من المقرر أن تستضيف مصر المؤتمر العالمي للصحفيين العلميين، إلا أن المؤتمر نقل إلى الدوحة نتيجة القلاقل السياسية. وبالرغم من ذلك، كانت الفعاليات التي شاركت فيها جديرة بالاهتمام؛ حيث جاء نصف المشاركين من العالم النامي وكان المؤتمر بالفعل عبارة عن تجربة متعددة الثقافات. وبالرغم من الاختلافات بين الشعوب، ما زال الصحفيون العلميون في كل أنحاء العالم يواجهون تحديات مشتركة – مثل أفضل الطرق للتواصل مع العلماء، والوصول لنطاق أوسع من الجمهور، وإتاحة الأخبار، وإجراء حوارات عامة حول الشؤون العلمية.
خطوات للأمام. بشكل مثالي، ينبغي على وسائل الإعلام أن تقوم بدور حيوي في تشجيع تفاعل الجمهور مع العلوم والتكنولوجيا. ولكن في دولة نامية مثل مصر، لا يتم الوصول إلى هذه المستوى من المثالية في الغالب. ويمكن تحسين هذا الوضع بعدة طرق. على سيبل المثال، ينبغي تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية للصحفيين العلميين. وينبغي على الاتحادات الصحفية المساعدة في تمويل مثل هذه الدورات، وينبغي عليها أيضًا رعاية مسابقات الصحافة العلمية وجوائزها. ويمكن أن تسهم أقسام الإعلام في الجامعات من خلال إنشاء برامج متخصصة في الصحافة العلمية.
لكن، ينبغي على الصحفيين العلميين أنفسهم المكافحة من أجل مهنتهم. لقد تعلمت في مرحلة مبكرة من مسيرتي المهنية أنه لا يكفي أن تقدم عملاً جيدًا، بل إنه من الضروري أيضًا أن تبيعه للمحررين، وأن تقنعهم بنشره بجانب الأخبار السياسية. وفي الوقت ذاته، ينبغي على الحكومة أن تترك الأمر للصحفيين ليقرروا ما هي المعلومات النووية المهمة التي ينبغي نشرها، وأن تدرك أن الرقابة لا تسهم في الأمن القومي. وفي واقع الأمر، يمكن للرقابة أن تجعل الجمهور أكثر مقاومة للمشروعات النووية. على سبيل المثال، لاقى مشروع الطاقة النووية المصري المقترح في الضبعة معارضة من السكان المحليين الذين انتابهم الغضب من نزع ملكية أراضيهم ، أو ممن تملكهم الخوف من الآثار البيئية والصحية السلبية للمشروع. وربما كانت الحكومة تستطيع التقليل من تلك المشكلات إذا بدأت في التواصل بصورة أكثر انفتاحًا مع الجمهور.