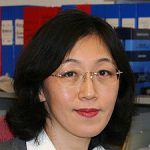السبل نحو إحياء عمليات منع انتشار الصواريخ
By Sitki Egeli: AR |
خرج عفريت تكنولوجيا الصواريخ من الزجاجة وما زال خارجها حتى الآن ولم يعد أمر عودته إليها هينًا بل صار أمرًا محالا. تمتلك الآن بالفعل ما يزيد عن أربع وعشرين دولة القدرة العلمية والتكنولوجية والصناعية التي تؤهلهم لانتاج صواريخ بالستية أو صواريخ كروز أو كليهما معا. ويرجع تاريخ التكنولوجيا الدائر حولها الجدل إلى ما يزيد عن سبعين عاما، هذا كما أصبحت للعديد من التكنولوجيات والمعرفة والمواد المتعلقة بالصواريخ استخدامات مزدوجة ما يعني أن تطبيقاتها المدنية والتجارية وانتشارها اصبح مشروعاً. وعليه فقد تلاشت بمرور الزمن الجهود المبذولة لتقويض عمليات انتشار الصواريخ.
يَصْدُق هذا القول على الرقابة على الصادرات بصفة خاصة، حيث عمدت نماذج متعددة من الترتيبات إلى الحد من تدفق الصواريخ مكتملة الصنع والتكنولوجيات والمواد المرتبطة بها إلى الدول التي لا تمتلك بالفعل أي منها. تقلل التجارة العالمية الآخذة في التوسع على الدوام من فعالية الرقابة على التكنولوجيا والصادرات حينا بعد حين، وهذا ما تحققه كذلك الأسفار السهلة منخفضة التكلفة عبر الحدود، وهذا يفسر التقدم المذهل في تخزين المعلومات ونشرها والتي نلحظ توافرها في تلك التطبيقات اليومية كالانترنت على سبيل المثال.
ومما زاد الأمر تعقيدًا، أن بعض الدول التي تظهر بمظهر "الفتى الطيب" في مشهد منع الانتشار تعمل على قدم وساق في مجال تطوير الصواريخ المزودة برؤوس تقليدية سواء كانت صواريخ بالستية ذات مدى قصير نوعا ما أو صواريخ كروز ذات مدى طويل نوعا ما وتلك الدول هي كوريا الجنوبية وتركيا وقد تنضم دول أخرى إلى القائمة عما قريب.
لماذا تسعى تلك الدول نحو امتلاك التكنولوجيات؟ لو أعملنا الفكر قليلا لأدركنا أن الصواريخ البالستية لن تفيد ما لم تقترن برؤوس حربية نووية، بمعنى أنها لن توفر بديلا تعبويا نافعا يغني عن القوة الجوية. سوف تفضل أية دولة لا يساومها حلم امتلاك السلاح النووي استخدام الطائرات المقاتلة خاصة في ظل توافر الموارد المالية والوضع السياسي اللازمين لحصولها على العناصر المتطورة اللازمة للقوة الجوية. غير أن تلك الحقيقة تجافي الواقع تمامًا، فما السبب وراء هذا التناقض؟
يكشف السخط من دول الجوار المنافسين عن جزء من السبب في سول وأنقرة، إذ لم تنفك كوريا الشمالية وايران وروسيا عن تطويرها الدائم للصواريخ وامتلائكها لترسانات صواريخ متنوعة دائمة التوسع، وهناك سبب آخر يحمل نفس القدر من الأهمية إن لم يكن أكثر من سابقه أهمية وهو مسألة التقدم في عدد من التكنولوجيات التي تساعد على تطوير الصواريخ. يدخل ضمن تلك التكنولوجيات تحليل وحوسبة المعلومات وتصغير الالكترونيات والملاحة والمواد المتطورة. ويساعد التقدم السريع في تلك المجالات على خلق جيل جديد من صواريخ كروز ومن الصواريخ البالستية التعبوية (ذات المدى القصير) التي تتمتع بدقة وكفاءة وقدرة تحمل عالية تفوق بها أسلافها من جيل سكود الذي لم يحظ بشهرة كبيرة. أصبحت الصواريخ البالستية قصيرة المدى – بما تحظى به من دقة يتم حسابها بعدد الأمتار- أدوات فاعلة في استخراج أهداف شديدة الخطورة ومحصنة بشكل جيد داخل إقليم العدو. يصبح التأثير على الهدف من لحظة إطلاق تلك الصواريخ أمرًا مضمونًا حقًا ومن الصعب أن يسري القول ذاته على طائرات الهجوم.
وهنا سؤال يطرح نفسه، إذا كان التقدم التكنولوجي يحول الصواريخ البالستية وصواريخ كروز إلى مقدرات نافعة ذات تكلفة ميسورة في الحروب التقليدية وإذا كانت النتيجة زيادة كبيرة في الطلب عليها، فهل هذا يعنى أن عصر الرقابة على الصادرات والتكنولوجيا قد ولى؟ وهل حان الأوان كي لا تساورنا المخاوف بشأن تلك الرقابة على الإطلاق؟
لا، ليس من الحكمة التخلي عن أعمال الرقابة.
لا زالت الرقابة على الصادرات والتكنولوجيا تزيد الأمر صعوبة على ناشري الأسلحة الحاليين والمحتملين ، حيث تتسبب في رفع التكلفة وإطالة أمد التطوير كما أنها تقضي على العوائق السياسية والسيكولوجية.، غير أن أعمال الرقابة الحالية التي يرجع تاريخ وضعها إلى ما يزيد عن ثلاثين عاما والداخلة ضمن نطاق نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ بحاجة إلى إعادة تمحيص وتعديل. لا تتماشى القيود العامة التي يضعها النظام مع التطورات الجديدة في المجال وعليه فقد ذهب تأثيرها أدراج الرياح، ولهذا فإن المنهج الأكثر فعالية لن يَتَأتَّى إلا بتركيز أعمال الرقابة على الأصناف والقطاعات الأكثر خطورة على انتشار الصواريخ.
تستطيع أن تركز أعمال الرقابة على سبيل المثال على الصواريخ طويلة المدى فكلما زاد مدى الصاروخ، قل اعتمادها على المعرفة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمتوافرة بقدر كبير، ولهذا فإن تطوير الصواريخ طويلة المدى يلقي على كاهل القائمين على عمليات الانتشار عددا من التحديات التكنولوجية والتقنية كإلزامهم بتزويد الصواريخ بمرحلة ثانية أو حتى ثالثة،وعلى الجانب الآخر فإنه يجب على القائمين على عمليات الانتشار أن يتعلموا كيفية التعامل مع الضغط والحرارة الشديدين المترتبين على الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض. وتثقل تلك التحديات كاهل القائمين على عمليات الانتشار بمزيد من المخاطر كما ترهقهم بتكاليف باهظة، هذا إضافة إلى مطالبتهم بالحصول على مجموعة متنوعة من الأصناف والتكنولوجيات المتخصصة كالمواد الغريبة المستخدمة للدخول مجدداً في في الغلاف الجوي ومكونات الوقود الدافع والمعرفة الخاصة بالتحكم في الصواريخ متعددة المراحل وعملية الانفصال. ويمكن للرقابة على الصادرات والتكنولوجيا أن تحدث تأثيرها العظيم إذا ما ركزت على الصواريخ طويلة المدى التي تثقل بالفعل كاهل القائمين على عمليات الانتشار بأكبر التحديات.
يجب على الرغم من ذلك ألا تكون الرقابة على الصادرات السبيل الوحيد للتعامل مع انتشار الصواريخ ،ومن بين السبل النافعة الأخرى التي يمكن اتباعها التقليل –يليه التخلص النهائي النموذجي- من جميع اختبارات الصواريخ. تتطلب عملية تنقيح تصميمات الصواريخ وضمان مدى الاعتماد عليها إجراء العديد من الاختبارات ولهذا وفيما يخص القائمين على عمليات الانتشار، تمثل الحاجة إلى اختبارات إطلاق شاملة نقطة ضعف، لأنه في حالة عدم القدرة على إجراء اختبارات سوف تتخلف عملياتهم الخاصة بتطوير الصواريخ وانتشارها، الأمر الذي قد يترتب عليها منعها كليةً، علمًا بأن هذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على الصواريخ طويلة المدى. علاوة على ما سبق، فإن الحد من إجراء اختبارات الصواريخ البالستية طويلة المدى يضيف ميزة أخرى ألا وهي: زيادة الاحتمال في أن تصبح تلك الصواريخ المرشح الأقوى لحمل الرؤوس الحربية النووية. يجب أن يحاول القائمون الجدد وغير الجددعلى عمليات الانتشار التأكيد على القدرة الاعتمادية لصواريخهم وإلا لن يكون هناك أدنى فرق بين صاروخ معيب أُطلِقَ وقت الحرب وبين رأس حربي نووي مُستنفَد. سوف تُحدِث كذلك الصاروخ المعيب الحامل لرأس حربي نووي مخاطر لا حصر لها تهدد السلامة ويرجع سبب ذلك إلى المادة الانشطارية الكائنة بها.
أما ما يدعوا للسرور في هذا الأمر فهو أن الأساس اللازم للبدء في حظر الاختبارات قائم بالفعل ويتمثل في: آلية ترعاها الأمم المتحدة تُعرف بمدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار الصواريخ البالستية ويتضمن هذا الاتفاق التطوعي غير الملزم الذي تبنته عدد من الدول في عام 2002 وصل عددها الآن إلى ما يزيد عن مائة وخمس وثلاثين دولة، تقديم تقارير سنوية حول اختبارات الصواريخ الباليستية،كما يتضمن الأحكام المتعلقة بالإخطار قبل الإطلاق. ويمكن تعزيز فعالية المدونة أثرها بعدة طرق مختلفة منها على سبيل المثال زيادة قاعدة الأعضاء بالمدونة وتعزيز آليات الامتثال وأخيرًا إضافة صواريخ كروز والمركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وأيضا الدفاع الصاروخي إلى نطاق المدونة. يمكن كذلك مراجعة المدونة لإدراج الإجراءات المتعلقة بالشفافية وبناء الثقة وإدارة الأزمة وهي إجراءات نفذتها بالفعل بعض الدول من خلال اتفاقات ثنائية.
نستنتج في نهاية الأمر أنه من الممكن تقويض عمليات الانتشار الأفقي للصواريخ (ويُقصَد بها الصواريخ المنتشرة في عدد كبير من الدول) عن طريق الدفاع الصاروخي الآخذ في الاكتمال بشكل سريع. ولنعلم جيدا أن أنظمة الدفاع الصاروخي مكلفة للغاية ولا تتوافر إلا للدول الثرية المتقدمة تكنولوجيا فقط، إضافة إلى أن مظلات الدفاع الصاروخي التي تقدمها تلك الدول لن تهدىء من روع الجميع، ولهذا فإنه من الممكن تعديل مدونة لاهاي الدولية لقواعد السلوك كي تقدم ضمانات تفيد بأن الدول غير الحائزة للصواريخ والواقعة تحت تهديدها سوف تتلقى تلقائيا مساعدة بالدفاع الصاروخي من أفراد المجتمع الدولي الراضين بذلك والقادرين عليه. قد تكون مدونة السلوك هذه رمزية إلى حد بعيد وقد يتوقف أمر تنفيذ الوعود الواردة بها على السياق إلى حد بعيد، إلا أنها ستساعد في وضع معايير دولية ضد نشر الصواريخ واستخدامها كما أنها ستفرض جوًّا من الهدوء والسكينة لدى الدول التي فضلت عدم الدخول في عمليات تطوير الصواريخ.